من مقاعد الدراسة إلى مقاعد البطالة
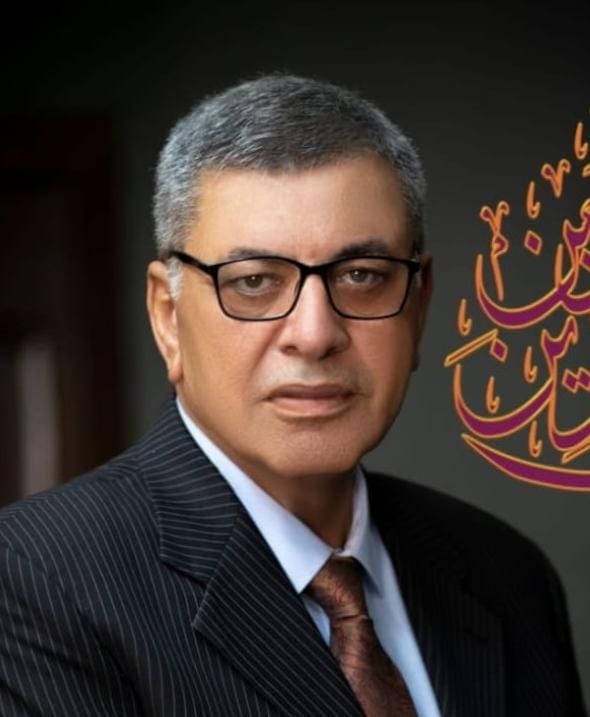
ديرتنا – عمّان
بقلم: زياد فرحان المجالي
في مجتمعاتنا العربية، كثيرًا ما تتحول المفارقات اليومية إلى نكتة مُرّة يتداولها الناس بضحكة باهتة تخفي وراءها وجعًا عميقًا. عبارة “ابتسم… أنت في دولة عربية” ليست مجرد سخرية عابرة، بل توصيف دقيق لحالة ممتدة من التناقضات التي يعيشها المواطن العربي منذ عقود.
يقضي الطالب العربي ما يقارب ستة عشر عامًا في مقاعد الدراسة، من الابتدائي حتى الجامعة، ليجد نفسه في النهاية إمّا عاطلًا عن العمل، أو موظفًا في وظيفة لا تمت بصلة لشهادته، أو بائعًا للخضار في السوق. ليس هذا لأن التعليم لا قيمة له، بل لأن سوق العمل العربي لا يُبنى على الكفاءة ولا على استثمار العقول، بل على شبكة معقدة من المحسوبيات والوساطات التي تحكم كل باب يُفتح وكل وظيفة تُمنح.
وفي الوقت الذي تكتظ فيه المقاهي بروادها من الشباب، تظل المساجد تشتكي قلة المصلين، والمكتبات تئن من الغياب. هذا ليس عيبًا في الشباب وحدهم، بل انعكاس لسياسات عامة أهملت الثقافة، وحولت أوقات الفراغ إلى طاولة نرد أو شاشة هاتف. مجتمع يترك مكتباته فارغة لا يمكن أن يحلم بمستقبل مختلف، لأنه ببساطة يستهلك يومه بدل أن يصنع غده.
أما الإعلام، فيغرق المشهد بفيض من الصحف والمجلات الرياضية أو الدينية، بينما تغيب المجلات العلمية والفكرية. خمس عشرة صحيفة تلاحق أخبار المباريات، ولا واحدة تهتم بابتكارات المخترعين أو مقالات الباحثين. كيف يمكن لعقل أن ينمو في مناخ كهذا؟ وكيف لأمة أن تلحق بركب الحضارة وهي لا تضع البحث والمعرفة في صدارة أولوياتها؟
ولا يقف التناقض عند هذا الحد. المواطن العربي يقود سيارة أمريكية الصنع، ويتناول “الهمبرجر” ويشرب “البيبسي”، ثم يرفع صوته عاليًا بمقاطعة المنتجات الأمريكية. المفارقة لا تكمن في الاستهلاك وحده، بل في غياب القدرة على صناعة بديل محلي يحفظ للناس كرامتهم الاقتصادية ويمنحهم استقلالًا حقيقيًا.
أمّا في عالم الوظائف والحقوق، فالقصة أكثر إيلامًا. الترقية لا تأتي إلا بالواسطة، والوظيفة لا تُنال إلا بالواسطة، وحتى الحقوق الأساسية لا تُنتزع إلا بالواسطة. تصبح الكفاءة والجد والاجتهاد قيمًا نظرية جميلة، لكنها غير كافية لعبور بوابة أي مؤسسة. والنتيجة أن الإحباط يتفشى، وأن الكفاءات الحقيقية إما تتوارى أو تهاجر، تاركة الفراغ لأصحاب النفوذ.
ثم تأتي القشة التي تكشف حجم الهوة: مئات الآلاف تُدفع لفنان أجنبي ليغني ساعة ونصف، بينما الملايين من الشباب العرب يعيشون بلا وظيفة أو دخل. هنا يظهر الخلل البنيوي بأوضح صوره: إنفاق على الترفيات بينما الأساسيات غائبة، ومكافأة للزائر الغريب بينما أبناء البلد غارقون في البطالة.
الابتسامة في وجه هذه المفارقات ليست دعوة للرضوخ، بل هي شكل من أشكال النقد الساخر. والواجب أن تتحول السخرية إلى وعي، والوعي إلى فعل. نحن بحاجة إلى إصلاح التعليم ليتصل بسوق العمل، وإلى إعادة الاعتبار للبحث والعلم، وإلى بناء منظومات سياسية واقتصادية تُكافئ الكفاءة لا الولاء. حينها فقط، يمكن للمواطن العربي أن يبتسم بحق، لا من باب التندر، بل من باب الفخر بأنه يعيش في دولة عربية تُنصف أبناءها وتستثمر في مستقبلهم

